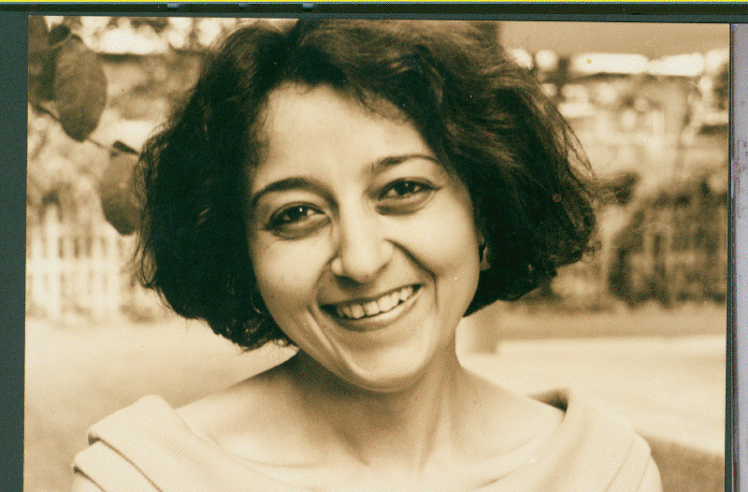قرأت "بيرة في نادي البلياردو"
في صيف 98 وكنت مهاجرة جديدة في مدينة بوسطن الأمريكية، لم يكن ممكناً أن أمارس
الكتابة ولا حتى كنت قادرة على وصف ما أمر به بعيداً عن القاهرة التي كنت أعدها
مدينتي لأصدقائي. قرأتها في وقت كنت أحتاج
فيه أن أقرأها لأفهم اغترابي في البلد الجديد لا في ضوء نوستالجيا سهلة للوطن ولكن
في ضوء تأصيل اغترابي الذي لم أفهمه كلياً عندما كنت أعيش فيه. بدأت بترجمة هذه
الرواية ليس لأنها رائعة وحسب ولكن لأنها أحد الأعمال القليلة التي أشعر تجاهها
بالامتنان. وقد ترجمت أكثر من نصفها بحماس ثم بدأت أتشكك في موقعي كمترجمة وانشغلت
بأشياء أخرى وتخوفت من أن تنضم إلى قائمة الأحلام التي لا تتحقق فاقترحت على صديقة
تعرفت عليها عندما انتقلت لأعيش في كندا أن تقرأ العمل وأن تترجم نصفه الآخرعلى أن
نحرره كله معاً وقد تحمست للمشروع، وكانت تجربة عمل مشتركة ممتعة.
صدرت" بيرة في نادي
البلياردو" سنة 1964 عن داراندريه دويتش بلندن، وأعيدت طباعتها عدة مرات بين
لندن ونيويورك، وقد وصفتها الكاتبة المصرية المعروفة أهداف سويف على غلاف طبعتها
الثالثة التي صدرت في نيويورك 1987 بأنها( واحدة من أجمل الروايات التي كتبت عن
مصر...)، كما حررت الأستاذة هدى الجندي كتاباً صدر عن قسم اللغة الانجليزية بجامعة
القاهرة يحتوي على دراسة عن الرواية، وهذا يعني أنها معروفة على الأقل لبعض المثقفين
والأكاديميين المصريين.
الرواية
في أحد مشاهد "بيرة في نادي
البلياردو" يفتح رام زجاجتين من بيرة استيلا المصرية ويصبهما في وعاء كبير ثم
يخفق السائل حتى يتخلص من الغاز مضيفاً شيئاً من الفودكا وشيئاً من الويسكي ليحصل
على أقرب شيء يمكن الحصول عليه من الدرافت باس- البيرة التي تعود عليها مع صديقه
فونت سنوات إقامتهما في لندن، والتي لا يجدانها بالطبع في مصر عبد الناصر بعد
رجوعهما إليها. رام وفونت لا يشربان هذه البيرة في أكواب محلية؛ فقد اشتريا لأجلها
قدحين من الفضة من طريق إدجار بلندن وحفرا اسميهما عليها وتعاهدا ألا يستخدمانها
إلا في شرب الدرافت باس.
هذا المشهد ليس تلخيصاً لأسئلة
الرواية ولكنه قد يكون أساسيّاً في فهم تعقيداتها سواء فيما يخص هوية شخصياتها أو
تداخل الثقافات واللغات وأشكال السرد بها أو حتى في فهم تعقيدات قراءاتها حيث توضع
الرواية في ضوء أدب ما بعد الكولونيالية حيناً وكنموذج ممثل لكوزموبوليتانية ما
قبل التحررالوطني حيناً آخر.
"رام"؛ الراوي في "
بيرة في نادي البلياردو" والمشترك مع وجيه غالي كاتبها في الكثير من الملامح،
ولد في إحدى الأسر المسيحية الأرستقراطية المصرية، يتكلم الفرنسية في البيت ويتلقى
تعليمه بالانجليزية في فيكتوريا كولدج. رام يعيش في مصر ولكنه لا يقابل من
المصريين إلا فئتين؛ النخبة التي تمثلها أسرته وأصدقائها من كبار الملاك ومحبي
السفر وأعضاء نادي الجزيرة الرياضي أو الفئة التي تخدمها من طباخين وسفرجية
وبوابين. علاقته الحميمة بصديقه فونت اليتيم الذي يشاركه غرفته تؤسس لاختلافهما عن
زملاء الدراسة لأنهما ببساطة "دودتا كتب"؛ يقرآن بشراهة ولايناقشان ما
يقرآن ، يقرآن الروايات والشعر بنفس الطريقة التي يقرآن بها التاريخ والفلسفة حيث
القراءة مجرد استمتاع بالقصص وكأنها منفصلة عن الواقع وغير حقيقية.
الحدث الوحيد الذي يعول عليه الصديقان
هو ثورة يوليو، وهو تعويل لن يستمر طويلاً عند رام على الأقل حيث سيحدث تحولاً في
حياته عندما يقابل إدنا سالفا؛ وإدنا يهودية مصرية شيوعية وابنة مليونير، تقدم
لفونت صداقتها وتكشف لرام مصر التي لم يعرفها. سؤال الهوية الذي بلوره الصديقان كل
بطريقته عبرعلاقتهما بإدنا هو ما سيجعل مما قرآه بدون أسئلة شخصية مصدراً لدعم
الأسئلة الشخصية. ولكن رام يحب إدنا وحبها يعلمه الوحدة. كما أن المنبع
الكوزموبوليتاني لشيوعيتها وقيامها بدور الدليل لرحلة وعيه يضعه في مأزق البحث عن
بديل لا لقوتها فقط - فهو لم يرها تبكي أبداً- ولكن لحبها أيضاً.
إدنا
تساعد الصديقين على تحقيق حلمهما بقضاء صيف في لندن حيث سيؤخذان بتجريب كل ما قرآه
في الكتب ويعود فونت أثناء حرب السويس ليلبس الجلابية ويبيع الخيار في شارع
الساقية. ولكن رام يظل هناك لأربع سنوات،
ينضم إلى الحزب الشيوعي الانجليزي ويتركه لأنه يرى أن من يقرأ الأدب والتاريخ
ويهتم بالناس على اختلاف أجناسهم وعنده الخيال اللازم سيلتحق بتنظيم شيوعي فإذا
كان مخلصاً فسيستمرفيه متخبطاً في عيوبه أما إذا كان صادقاً فإنه سيتركه؛ ورام يرى
نفسه "غير مخلص ولكنه صادق". يعود رام إلى مصر حيث ينظر إلى نفسه كشخص فقد
في أوربا أجمل ما فيه نهائياً وإلى الأبد، وحيث يعيش بوجود منقسم في شخصين أحدهما
يمثل والآخر يتفرج على الأداء في مسرحه الخاص. يكتشف رام أنه ببساطة شخصية مفترضة وأنه عالة وهو المثقف الشيوعي – كما يرى نفسه- على
أصدقائه الذين ظلوا أغنياء رغم ثورة يوليو . يدفع رام فونت للعمل في نادي
البلياردو حيث ينظف الطاولات بالملحق الأدبي للتايمز ويجهز الكور للاعبين . فونت يعيش
في مصرخارج المكان لأنه يظل ملحقاً على انجلترا وأحداثها السياسية معطياً لرام
موضوعاً لتأمل هذا الملمح في ذاته: "بدأ فونت ينظم كور البلياردو لهما. أنهيت لتراً
من هذه البيرة مما أراحني وسمح لعقلي الشرقي أن يتساءل عن أشياء غير شرقية مثل
فونت، وفونتات آخرين كنت قد عرفتهم، وحتى الفونت الذي أكونه أنا نفسي أحياناً.
الفونتات الذين ليسوا كيرهارد(ات) ولكن جيمي بورتر(ات) في العصر الفيكتوري المصري؛
الفونتات الذين ليسوا ثوريين ولا زعماء في الصراع الطبقي ولكن منتجات مهذبة لـ (اليسار)
الانجليزي ، وحيدون وبلا مجد في ثورة العالم العربي الناهضة".
سؤال رام عن هويته يلتبس بأسئلته الأخلاقية وبشكوكه
وسخريته من اختياراته والتي ستنتهي الرواية بأكثرها مأساوية. وهذا هو ما يعطي لهذه الرواية فرادتها بين
روايات ما بعد الكولونيالية بشكل عام وبين الروايات العربية التي تمثل أرشيفاً
للكتابة عن تجربة الوجود في الغرب بشكل خاص. لقد قرأنا "عصفور من الشرق"
و"قنديل أم هاشم" و"موسم الهجرة إلى الشمال" وغيرها مما يقدم
طرحاً لمأزق هوية الذات الكاتبة وبحثها عن تاريخيتها في ضوء تقاطع مع الآخر-
الغرب، ولكن قراءة مأزق هوية رام تختلف عن الأخريات؛ فرام لم يطمح إلى توليف هوية تتصالح فيها ملامح
من الثقافتين كما فعل محسن- توفيق الحكيم وأبطال آخرين أبدعها أبناء جيله
بليبرالية أصيلة، ولم ينته مثل اسماعيل- يحيى حقي بعلم الغرب ليختار معجزة
وروحانية زيت القنديل ليشفي به عيون فاطمة ، ولم ينه حياته كما فعل مصطفى سعيد-
الطيب صالح بالرجوع إلى النيل حاملاً سره وممارساً غربته في قرية صغيرة. فرادة رام
ليست فقط في أنه إنتاج مشترك لثقافة المستعمِر والمستعمَر في ذات اللحظة بل في أنه
أيضاً فشل في أن يجد مكاناً لروحه في داخل الثقافتين؛ لقد كان قومياً لا يقبل
بقومية عبد الناصر ولا ينجرف مع كوزموبوليتانية إدنا ، وشيوعياً لا يحترم عدم
اهتمام الشيوعيين المحليين بحقوق الانسان ولا يحترم نفايات الفابية الانجليزية،
لقد كان مجنوناً بالأناقة وبرفاهية الأرستقراطية وناقماً على أنانية وتفاهة أفراد
أسرته المنتمية إلى هذه الطبقة. هوية رام هي وعي فردي تم بناءه على حافة كل شيء
وفشل في إيجاد حل لأي شيء ولهذا تقلق شخصية رام قارئها وتضع قناعات هذا القاريء
تحت طائلة سخريتها المرة التي لا تريد حلاً بقدر ما هي تريد أن تتفرج.
سخرية رام كانت وراء ما عده أكثر من ناقد بعضاً من أجمل
مقاطع النثر الانجليزي ؛ إنها سخرية وعي
بطلها الحاد وكلبيته في نفس اللحظة. عندما يذهب في أول مشهد في الرواية ليقترض
نقوداً من خالته الغنية والتي كانت مشغولة بتوقيع عقود صورية تبيع الأرض فيها
للفلاحين لترى صورتها مطبوعة في صحف الغد وتسأله صديقة الخالة هل تعمل الآن؟ يرد:
"اكتشفت طريقة جديدة لاستغلال الفلاحين، وكل ما أحتاجه هو رأس المال"، إنها
سخريةلا تضحك جمهوره داخل السرد ولا تسلي قارئه خارجه. وعي رام يفجر في وجهه مأزق
هويته كمصري لا يتكلم العربية، كمواطن كوزموبوليتاني يحاول الهروب من تعدده
الثقافي لينتمي إلى مكان ولادته عبر اثبات أن دمه خفيف وأن خفة الدم هي هوية
المصريين؛ إنه يتأمل فونت الذي يشترك معه في هذا المأزق ويسخر منه: "وضع سخيف أن يجلس مصري في القاهرة
حانقاً بسبب موقف جيتسكل من تصنيع الأسلحة النووية في انجلترا ولكن ذلك لا
يخطر ببال فونت (...) مثلما كان يفعل Lucky Jim في انجلترا خلال أيام ديكنز. كان ذلك مثل محاولة
دهن كعكة بالكريم بينما هي لا تزال في الفرن. فونت يعرف كيف يزين الكعكة ويكسوها ويزودها بأحدث الزخارف، ولكنه لا يعرف
كيف يخبز واحدة. لهذا عليه أن ينتظر عبد الناصر ليخبزها له قبل أن يتمكن من إدخال
تحسيناته عليها- وهو ليس متأكداً تماما
ًإن كان سيُسمح له بذلك، حتى فيما بعد. أما في الوقت الحالي فهو يجلس
ويقيّم كل الكعك المخبوزآملاً أن تطلع الكعكة المصرية أوالعربية بالشكل الصحيح). ولكن نتاج هذا الوعي الساخريقف عند المزيد من الضحك الغاضب والاكتئاب(
عندي هذه العادة الحمقاء
من الضحك المفاجيء. بالفعل رأيت الكعكة في خيالي، ولم تكن مستوية السطح ولا ملساء
كما كنت أتمنى. رأيت نفسي أقضمها هنا وهناك. عندها بالطبع كنت سكراناً ومسألة
الكعك هذه بدت طريفة للغاية، خاصة القضم. فقهقهت بصوت عال".
وجيه غالي
في 26 ديسمبر 1968 ابتلع وجيه غالي
علبة كاملة من الحبوب المنومة في شقة الناشرة والكاتبة الانجليزية ديانا أثيل ومات
في إحدى مستشفيات لندن في 5 يناير 1969. ربما تكون هذه المعلومة الوحيدة الأكيدة
التي نعرفها عن غالي دون أن يكون مصدرها كتابته أو تصور الآخرين عنه؛ ترك غالي
روايته الوحيدة "بيرة في نادي البلياردو" ومسودتين بخط يده لرواية كان
يعمل عليها في الشهورالسابقة لانتحاره وكان يشير إليها في مذكراته بـ " Ashl novel"، إحدى المسودتين عبارة
عن 37 صفحة والأخرى 32 صفحة وكلاهما يحتوي على تصحيحات آخرها بتاريخ أكتوبر67.
وهنا أريد أن أشكر الكاتبة ديانا أثيل على اعطائي نسخة مصورة من المسودتين ومن
يوميات غالي غير المنشورة والتي تقع في ستة أجزاء منفصلة وتغطي اقامته في ألمانيا
في أول الستينيات ثم سنوات إقامته في لندن.
 رغم صعوبة تحديد تاريخ ميلاد غالي
بدقة لأنه لم يكن صادقاً في الاعتراف به إلا أنه يمكن القول أنه ولد في نهاية
العشرينيات من القرن العشرين؛ فقد درس في فيكتوريا كولدج في الفترة من 44 إلى
1947، كما أنه في يومياته وأثناء زيارة أحد أصدقائه- الممثل المصري أحمد رمزي
للندن في سبتمبر67 يشير لصداقتهما منذ الطفولة ولتزاملهما في الدراسة. من مذكرات غالي
وروايته وكتاب أثيل عنه والمعنون" بعد الجنازة" يمكن رسم صورة غائمة
لطفولة مشتتة بين بيت جده لأمه وبيوت بعض الأصدقاء. كان طفلاً وحيداً ولا يتذكر
والده الذي مات مبكراً. فقر والدة غالي لم يمنعه من الحياة ملحقاً على أسرتها الارستقراطية
رغم وعيه بهذا التناقض. يذهب لباريس ليدرس الطب في السربون ولكنه لن يحصل على
شهادة ويغادرها إلى لندن في مايو 53 ثم إلى مصر بعد انتهاء جواز سفره المصري وخوفه
من السجن لأنه ضرب ضابط بوليس انجليزي أثناء مظاهرة ضد العدوان الثلاثي56 . يعود
غالي إلى القاهرة ويكتشف أن طبقته ما زالت تتمتع بنمط حياتها رغم ثورة يوليو ويتورط
في نشاط شيوعي ويخاف من السجن، ترفض الحكومة المصرية تجديد جواز سفره فيهرب إلى
ألمانيا التي تمنحه إقامة في 58 ولكنه يعيش في بلدة صناعية صغيرة متنقلاً بين
وظائف قاسية ويكتب "بيرة في نادي البلياردو" ويبدأ علاقة مراسلة مع ديانا
أثيل التي تتحمس لنشر روايته ويزورها في لندن سنة63 ثم يتقابلان في بلجيكا ويسألها
أن تنقذه من ألمانيا فتساعده على الحصول على إقامة في انجلترا ويذهب ليعيش في رعايتها
منذ 1964 وحتى انتحاره.
رغم صعوبة تحديد تاريخ ميلاد غالي
بدقة لأنه لم يكن صادقاً في الاعتراف به إلا أنه يمكن القول أنه ولد في نهاية
العشرينيات من القرن العشرين؛ فقد درس في فيكتوريا كولدج في الفترة من 44 إلى
1947، كما أنه في يومياته وأثناء زيارة أحد أصدقائه- الممثل المصري أحمد رمزي
للندن في سبتمبر67 يشير لصداقتهما منذ الطفولة ولتزاملهما في الدراسة. من مذكرات غالي
وروايته وكتاب أثيل عنه والمعنون" بعد الجنازة" يمكن رسم صورة غائمة
لطفولة مشتتة بين بيت جده لأمه وبيوت بعض الأصدقاء. كان طفلاً وحيداً ولا يتذكر
والده الذي مات مبكراً. فقر والدة غالي لم يمنعه من الحياة ملحقاً على أسرتها الارستقراطية
رغم وعيه بهذا التناقض. يذهب لباريس ليدرس الطب في السربون ولكنه لن يحصل على
شهادة ويغادرها إلى لندن في مايو 53 ثم إلى مصر بعد انتهاء جواز سفره المصري وخوفه
من السجن لأنه ضرب ضابط بوليس انجليزي أثناء مظاهرة ضد العدوان الثلاثي56 . يعود
غالي إلى القاهرة ويكتشف أن طبقته ما زالت تتمتع بنمط حياتها رغم ثورة يوليو ويتورط
في نشاط شيوعي ويخاف من السجن، ترفض الحكومة المصرية تجديد جواز سفره فيهرب إلى
ألمانيا التي تمنحه إقامة في 58 ولكنه يعيش في بلدة صناعية صغيرة متنقلاً بين
وظائف قاسية ويكتب "بيرة في نادي البلياردو" ويبدأ علاقة مراسلة مع ديانا
أثيل التي تتحمس لنشر روايته ويزورها في لندن سنة63 ثم يتقابلان في بلجيكا ويسألها
أن تنقذه من ألمانيا فتساعده على الحصول على إقامة في انجلترا ويذهب ليعيش في رعايتها
منذ 1964 وحتى انتحاره.
يوميات غالي وثيقة هامة لتأمل حالات
العجزعن الكتابة ولاغتراب كاتب عاش طفولته فاقداً لبيت وشبابه فاقداً لوطن. وهي
سجل لتعليقاته عن قراءاته وعلاقته بالسينما وتصوراته عن الآخرين الذين مثلوا عالمه
في لندن ومنهم ديانا أثيل التي لم يحبها وإن كانت وفرت له أمومة ورعاية كان لا
يستطيع النجاة بغيرها. أيضاً تفسر
اليوميات ملابسات زيارته لاسرائيل في نفس سنة الهزيمة وقصة مقالاته عن هذه التجربة
للنيويورك تايمزوالأكثر من ذلك فإن هذه اليوميات هي دليل على تدمير غالي لذاته
بشكل منتظم ولسنوات قبل أن يقرر أن ينهي آلامه باختيارالتخلص منها.
ما نشره غالي:
1964. Beer in the Snooker Club. London: Andre Deutsch,
1964.
1967. “An
Egyptian Watches Arab Anger Rise.” The
Times. (10 August), 6.
[Unsigned
Sidebar: “To the Left of Nasser.” The Times. (10 August 1967), 6.]
1967. “An
Egyptian’s Report from Israel.”
The Times. (1 September), 9.
1968. “An Egyptian
in Israel.”
The Listener. 79 (11 January), 50-52.
[Transcript of radio commentary aired by the BBC 3rd Programme on 10 December 1967.)
ما تركه غالي ولم ينشر:
- 6 أجزاء من المذكرات تغطي يومياته في ألمانيا حتى سنة 64، وفي لندن حتى
ديسمبر 68.
- مسودتين من رواية لم تكتمل بعنوان"
رواية أشل" مع تصحيحات بخط يد الكاتب، الأولى 37 صفحة والثانية 32 صفحة.
كتابات عن وجيه غالي:
Athill, Diana. Obituary for Waguih Ghali. The Times.
(11 January 1969),
10Athill, Diana. After a Funeral. London: Cape,
1986.
Colla, Elliot.
“Belated Review of a Stella(r) Literary Performance. (unpublished review,
obtained from author 2/1/99).
Hibbard, Allen.
“Cultural Upheaval and Fictional Form: Three Novelistic Responses to Nasser’s Egypt.” Liminal
Postmodernisms: The Postmodern, the (Post-)Colonial, and the (Post-)Feminist.
Theo D’haen and Hans Bertens, eds. Postmodern Studies 8. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1994.
Gindi, Nadia. “The Gift of Our Birth: An Image of Egypt in the
Work of Waguih Ghali.” Images of Egypt in
Twentieth Century Literature. Proceedings of the International Symposium on
Comparative Literature. 18-20 December 1989. Hoda Gindi, Ed. Cairo: Cairo
University English Department, 1991.
نشرت هذه
المقالة مع الجزء الأول من بيرة في نادي البلياردو في أخبار الأدب سنة 2006