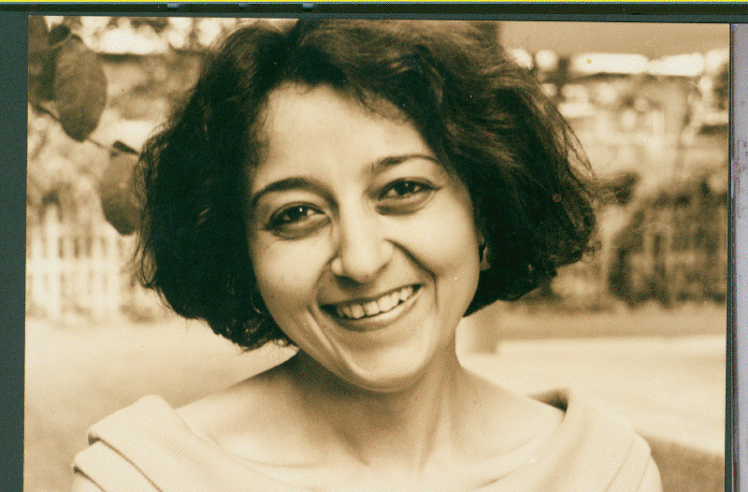عيـن ترصـد التفاصـيل والذكـريات بتمـهل
ماجد المذحجي
الانتحاء جانباً، واتخاذ موقع ملائم لتركيز عين متمهلة ترغب بمراقبة " حياة تمر من بعيد "، لا يبدو كافياً كمدخل لتوصيف، أو لتكثيف مزاج عمل كـ ( جغرافيا بديلة )، المجموعة الشعرية الأخيرة لـ " إيمان مرسال "، الشاعرة المصرية المقيمة في كندا، والصادر في القاهرة عن دار شرقيات، في الـ 2006م. بل هو انتخاب ذاتي ( لاقى هوى شخصي شديد ) لأحد الأنشطة التي تمارسها نصوص المجموعة، والتي تتجاور مع أنشطة أخرى، تتفحص عبرها " الشاعرة " ذاتها وهي تنشئ " جغرافيا بديلة "، تسوغ لها أن تتعامل بندية بالغة، وباستقلال مفترض ومريح، مع ارث الذاكرة المتداخلة بعمق مع خلفيتها غير المحايدة، والتي تنتظم بمجملها في جغرافيا ممتدة، حيث صياغات الانفعال الأول، والوعي الأول، والارتباك الأول، ممتدة بإصرار غير ثقيل حتى الراهن أيضاً من هذه الانفعالات والوعي والارتباك!!. باعتبار كل ذلك مسرح للحياة التي تترهل في الداخل بصمت، مكونه فرص شعرية مهملة، لا يُمكن إدراكها إلا بنظر متمهل، ومن غير توقعات مثقلة بالمحاكمات، أو تسجيل الانتصارات، لان ما تُخلفه الحياة في تدافعها من إرباكات، ومواقف، وذكريات. لا يُمكن إدراكه، أو تأمله، وتحويله لاحقاً إلى " حكاية شعرية " مقلمه، وأنيقة، وعميقة، إلا من موقع مرتفع قليلاً قد يكون " جغرافيا بديلة "!!.
ذات الجغرافيا التي لا يُمكن تركها مُعرضة لأي اهتزازات، أو مفاجآت تُربك هذا الاستقرار المدهش، الذي مكنها من قذف كل هذه المتعة اللغوية والذهنية خلف غلاف أنيق لم يُكثر من التقولات والادعاءات البصرية ( تصميم غلاف المجموعة هو إهداء للشاعرة من المصممة الألمانية تيجر شتانجل )، بل اطمئن إلى السلام الذي يلف المتن الذي يُفصح عنه، وتناغم مع الذكاء والخفة الشديدة التي تميزه، و ركن إلى بعثرة خارطة العالم كلها على ألوان مُسترخية ومُطمئنة، بمزاج طفل لا تتزاحم في جمجمته أي توقعات، عن ما تُحدثه أفعال كهذه من مُسوغات لبشر يتراصون خلف بعض بتحفز وانتظار، لابتكار المآسي الشخصية والعامة.. والاحتفال بسردها لاحقاً!!.
إنها تعمل ضمناً في نص ( لماذا جاءت )، أول نص في المجموعة، على التأمل في ما يبنيه الغريب من أساطير حول ذاته في الأمكنة الجديدة، تتعلق بتأبيد الحنين، وتعميق فكرة الولاء، وهشاشته التي تُُفصح عنها المركزية الشديدة لأولئك البعيدين الذين ينشغل دوماً بإثبات ولائه لهم، وكونه لم يتغير أبداً، بأن ( يكرر " الحمد الله " كثيراً حتى يطمئنوا على إيمانه ). وهي تتفحص هذا الوافد إلى ارض جديدة، بغربته، وتلفته، وذعره المزمن. عبر تسليط الضوء على القفص السري الذي ينغلق ضمنه، وعبر ملامسات أنيقة لهشاشة فكرة الانتماء، والاقتران الأزلي بضرورة العودة، ومحاولة حراستها بفكرة مثل العودة للوطن ولو ميتاً!!، فالمهاجرين ( يحلمون بالعودة عندما يصبحون جثثاً )، وحين لا يستطيعون، يعلقون هذه الفكرة كالجرس في أعناق أولادهم، ويلحون عليهم ( يجب ان تحملونا إلى هناك - هكذا يتركون الوصايا في أعناق أولادهم - )!!. إنها تتهكم على إصرار هزلي على فكرة الاطمئنان لنهاية سعيدة، ولموت مريح في الأخير، ربما ستجعل منهم أجمل وأكثر اطمئناناً، وهو شأن لن يتم إلا بالعودة إلى التربة الأولى ولو ميتين!!. رغم أن الموت لا يعبئ بترك الناس ممدين وعاريين في تربة غريبة، أو تربة وطنية، و( كأن الموت هوية ناقصة لا تكتمل إلا في مقبرة الأسرة )!!. إن الجملة المفتاحية في هذا النص، والأولى في المجموعة، مُعلقة إلى سؤال مباشر يكشف عن رغبتها في تفحص موقعها النفسي و " المكاني " الجديد ( في هذا النص، وفي المجموعة ضمناً، مع استبطان الوافدين إجمالاً، كما ستكشف الأنشطة الأخرى التي ستنهض بها النصوص، وأن كانت لا تختصر صوتهم عبرها، وإنما تستعير ارتباكهم وهشاشتهم لتضيء علاقات نفسية و " معرفية " مُهملة، وصور شعرية مركونة جانباً، استطاعت استثمارها بلغة أنيقة فعلاً ) ضمن إدراكها للحمولة الثقيلة للهوية الملتصقة بها قسراً ( لماذا جاءت إلى البلاد الجديدة؟ هذه المومياء، موضوع الفُرجة ). إن هذا الافتتاح ألتساؤلي، يؤسس لبناء إدراك لاحق بالمكان الجديد، والنفسية المختلفة، ضمن مزاج مقارنه حذق وخفيف مع المكان الأساس، الذي قدمت منه، مع الاعتناء بشكل رئيسي بالأفراد في المكان، وبكيف يعيش الناس هنا وهناك، لا بالمكان لذاته!؟ ( هنا أيضاً أشجار خضراء تقف تحت ضغط الثلج، وأنهارٌ لا يتعانق بجانبها عشاقٌ خلسة، بل يجري بموازاتها رياضيون مع كلابهم في صباح الأحد ). إن هذا الوافد والغريب الهش، الذي سيظل مُعلق دوماً إلى أمنيات أزلية بالعودة، والغارق بإصرار في وحل الذكريات، هو موضوع تشريحها.. وغضبها النادر أيضاً ( لماذا لم ينسوا أنهم من هناك؟ الغرباءُ الفَشَلةُ )، وتهزئ من محاولات سطحية باهته للامتزاج بالمكان الجديد ( يدربون عضلات أفواهم على التخلص من اللكنة ) هذا ما يحاولونه فقط!، وهي محاولات تكشف هشاشتهم، وتفضحهم في الانفعال الذي يعيدهم بقسوة إلى جذورهم البدائية ( اللكنة هي المرض الوراثي الشفاف الذي يفضحهم، يقفز عندما يغضبون فينسون كيف يضعون أحزانهم في لغةٍ أجنبيةٍ ). إنهم لا " يضعون " أحزانهم في المكان الجديد، في اللغة الجديدة، حتى يصبحون جزء منها، و جزء من شراكه متينة في الهوية الجديدة بشكل حقيقي. إنها أحزان مُعلقه في الهواء، ومازالت تؤشر كالبوصلة نحو الهوية والانتماء الأول بإصرار!!. إنها تستخدم فعل " يضعون "، بإشارة واضحة إلى أن الاتصال بالمكان الجديد، يجب أن يكون فعل واعي تماماً، لان المقص الذي يقطع صلتهم به هي عواطفهم الغبية.. والمتقدة باستمرار!!. إذاً، فان التفضيل العقلاني، غير المرتهن لولع عاطفي، هو ما سيبني انتماء جديد، وهوية بديلة، كما يستبطنه هذا التفضيل لفعل ( يضعون ) تحديداً عن غيره من الأفعال، وموضعته في هذا المقطع من النص!!؟.
( في قارةٍ أخرى، تركت أعداء مساكين، يجب أن تخجل من نفسك عندما تتذكرهم.. لا شيء يغضبك الآن، ) هذا بالضبط ما ينشئه المكان الجديد، مساحة داخلية واسعة، بالمعنى النفسي ضمناً، يصعب جعلها ضيقه ومتوترة، ويجعل من المسافة ذاتها مبرراً للتسامح تجاه كل البشر، وتجاه الأشياء التي كانت تُثير التذمر هناك في " الوطن "!! ( من الصعب أن تقابل شيوعياً كلاسيكياً هنا، حتى إنهم يضعون ساعةً في المكاتب العمومية بدلاً من صورة الرئيس. )!!. لا توجد إذاً مبررات للغضب، كل شيء يسلبك هنا ما كنت تغضب منه هناك ( لا شيء جدير بأن تتمرد عليه. أنت مرْضيٌ وميتٌ والحياة من حولك تبدو مثل يدٍ رحيمةٍ أضاءت الغرفةَ لعجوزٍ أعمى ليتمكن من قراءة الماضي. ). إن كل هذا الانتظام، هذه الحياة الجديدة، الأشياء التي لا تبعث على التوتر، مُربك فعلاً وبشكل حقيقي لـ " ذات " تعودت أن تنفعل لمعطيات شائعة بكثرة هناك.. فالناس هنا ينفعلون لأسباب أخرى نجهلها، أو لأننا لم نُكون تفضيل نفسي، أو معرفي، أو حقوقي جديد، تجعلنا نختارها كأولوية ومنطقة اهتمام ننفعل لأجلها تبعاً لما تتعرض له، وهو ما يجعلها - تبعاً لعدم قيامها بانتخاب تفضيلات مختلفة عن السابقة يستدعيها الموقع الجديد، ولعدم انسجامها الكامل والفعلي من الأنساق المعرفية والنفسية واليومية الجديدة، كما يقول منطوق النص الظاهر طبعاً، لا إسقاطاً مباشراً على الشاعرة ذاتها، وهو إسقاط سيبدو فجاً لو أعتسف سياق كتابتي وتأويلي فهم المتلقي باتجاهه - كعجوز أعمى يعيش سلامه الأخير ومنشغل تماماً بـ " قراءة الماضي ".. ذلك الذي سيكون موضوع نص أخر وجميل بالفعل من نصوص المجموعة؟؟.
في ( قراءة الماضي )، يتم تنشيط وعي بالذاكرة المنسية، أو ربما المتروكة جانباً في انشغالات المكان الجديد، حيث ( ستجلسُ في مكتبها في سَمت الأستاذة )!. إنه وعي أكثر حرية الآن، لأنه متخفف من قيود الذاكرة، كون موقع النشاط الذي أنشئت منه مكوناتها صار بعيداً، أو لان العودة إليه صارت مسنودة بـ " ذهنية مختلفة "، و" نظر مختلف " للأمور. وبالتالي سيتم ترتيب إدراك مختلف لماهي عليه، ولموقع الأطراف الأساسين فيها. إن عبئها أقل ربما، فـ ( الذاكرة؛ موضوعٌ مناسبٌ لتغطية الرعشة التي مرت فوق كوبين من القهوة ).. ربما!!؟. إنه وعي بالذاكرة يستقل عنها، رغم " الارتعاش " لها. ينظر إليها من موقع أعلى قليلاً، ويشتغل بشكل ما ضمن مزاج " سينمائي "، لا يتم فيه تثبيت المشاهد، بل جعلها تمر ببطء، وضمن احتواء كامل لا يُهمل التفاصيل، وما تُشير له ( كان الروائيُ الشابُ قد ترك الشاعرةَ الشابةَ مدعية النوم أرادت أن تثبِّتَ لحظةَ الوداع وهي عارية تحت ملاءة شفافة وألا تلتفت قررتْ أن تظل هكذا حتى يعود من تجربة الغرب مدعيةً النوم... عاريةً... وتحت ملاءةٍ شفافةٍ ). رغم ذلك، تقر في نفس المتن انه لا يمكن خلق مسافة واحده، ومتجهمة، من تفاصيل الذاكرة!؟. إن اتخاذ موقع متعالي أثناء تفحصها وسردها، لا يرتب " انفصال عاطفي " عنها، بل قد يكون أيضاً مبرر ضمني لترتيب سيناريو لما لم يُقال حين حدثت، أو ما نُريد أن نُلحقه بها حين نريد التخلص منها.. ربما ( فكرتْ انه قد يتعلم هناك أن يبطئ من خطواته.. أنها تستطيع عندما يعود أن تمشي بجانبهِ دون أن تلهثَ )!!. سيكون عليها بعد ذلك أن تصرح بكل شيء، بالتباسه العاطفي والنفسي، متخففة من فكرة كون ( قراءة الماضي ) ليس سوى فار تجارب ممد على منضدة تشريح، نُجرب عليه - بحيادية كاملة - مباضع " الوعي الجديد "، أو فرصة" القراءة الجديدة " الأكثر حرية وشفافية، والأقل مسؤولية - ربما - بالمعنى " الأخلاقي " و " والعاطفي "
( لماذا لم اكتب عنك قبل ذلك؟ لأني لم أحبُّكَ أبداً، لهذا لا أصدِّق موتَك؟ لأني أحبُّكَ وكان عادلاً أن تموت؟ لأنك لا تستحقّ رثائي فقد كنت ألهثُ عندما نمشي معاً؟ لأني لا أستحقّ أن أرثيك ما دمت حيّة؟ لأن عازفَ البيانو في الغرفةِ العلويةِ يضغطُ على الأصابع السوداء؟ لأنك حاقدٌ عليّ؟ لأني أريدُ أن أخونك مع الطالب؟ لأني غاضبة؟ لأن كليْنا ميت بينما الذاكرةُ عاريةٌ تحت مُلاءة شفافة؟ لأن طالب الأدب المقارن يجب أن يموتَ أولاً؟ لأن صوتَك يعيش في جسدٍ آخر؟ لأنني لم أَعُد بعد من تجربة الغرب؟ ).
أوردت هذا المقطع الطويل والجميل، بنبرته الصوتية العالية والواضحة، لأنه يُفصح بشكل ما عن موقعين، عاطفي ونفسي، تنازعا سرد أحدى فقرات " الموقع الجديد " من الذاكرة ، والذي أراد لتدوين النص أن يكون محايداً تجاهها!؟. لا يمكن تسمية ذلك بالفشل، وكم يبدو غبياً وفجاً استخدام تعبير " فشل "، أثناء قراءة نصوص لا تحترم الاستخدام السهل والسطحي للكلمات أبداً، بقدر ما هي " نزاعات " في الوعي، و مزاج النظر، والسرد، بين " تجربة الوطن "، و " تجربة الغرب " ( لأنني لم أَعُد بعد من تجربة الغرب؟ ). أو ربما فان المسألة هي رغبة ضمنية في الكشف عن التناقضات، والارتباكات، التي يمكن أن يقع بها الفرد أمام الذاكرة، في أي وضع كان يحاول أن يُرتبه لقراءتها، والتي تُفصح عن هشاشته ضمن أي وعي كان يعمل ضمنه!!؟؟.
عن اللغة وما تُخفيه.. أو ربما عن مشاهدتها عارية، ومرتبكة، وأنيقة...
لا تقف إيمان في كافة نصوص المجموعة، في موقع المشدوهة لفكرة " المهاجر "، وتداعيات الاغتراب فقط!؟. بل يتسع " نظرها "، ليتفحص علاقات اللغة ذاتها، حين تستمر بإنتاج معاني تم التلاعب بها، وتسريب انحيازات مُسبقة إليها، خصوصاً حين تتصل بالمرء ذاته، فتعمل لذلك على الاحتجاج عليها، بنبره هادئة وواضحة تماماً، وتنحاز، أو تُعيد الاعتبار، إلى ما يُمكن أن يكون شبيهاً بما تعنيه، لا إلى ما يُراد له أن يتقول عنها ( يقول الطبيبُ أنت " حامل " تقولين لا أنا حُبلى ليس لأن الصفة تنقصها " تاء التأنيث " ليس لأن اللغةَ العربيةَ غيرُ عادلةٍ لكن لأن " حُبلى " هي الكلمة التي تجعلك ممتلئة بنفسك أنتِ حُبلى إذن. ). إنه موقع من اللغة، لا يميل للاستسلام للتزييف الذي تمارسه ضمناً، أو يُقر بسهولة ما تستبطنه ضمناً من أحكام، ومواقف متحيزة. بل يعمل على التفكير بها، والنفاذ إلى عمق مقولاتها. إن هذا الموقف ينسحب على أدائها الشعري بشكل عام وواضح، فهي تعمل في اشتغالها الشعري، على العبث الذكي، والمتمكن باللغة " المستقرة "، و " الراكدة "، تلك التي بليت من الاستخدام المتكرر، في وظائف وتعبيرات ثابتة. إنه فعل واعي، ولكن ( الأمرُ لا يخلو من نوايا أدبيّة ) وهو ( مثلُ كَشْطِ الصدأ عن كلمة " غرام " نفسها وغسْل كلماتٍ مثلِ " هَجْر "، " وصال "، " ضَنا " من اللعاب الذي بلّلها أثناء الغناء. ).
إنه موقف معرفي بشكل ضمني، ينحو باتجاه فهم جذور " الكلام "، و " الكلمات "، يتفحص ما تُحدثه بنا، عبر التفكير بصوت عالي وواضح، و بسرد غير خجل، بجوهر وظائفها، فمثلاً ( ينجح الغرامُ في جعْلنا أصلاءَ وأنانيين، أنانيين بأصالة وأصلاءَ في أنانيّتنا... الخ ولاشيء يكفي حتى ليبدو ذلك الذي قال أن القناعةَ كنزٌ لا يفْنى وكأنّه ثبَّت الحواسَ في درجة الصفر ماشياً صوب الصحراءِ وهو يصفِّر بلحنٍ يشبه: أنا أنت وأنت أنا ).
إذاً، لا تعمل إيمان مرسال في نصوص هذه المجموعة - والمجموعات السابقة أيضاً - على العمل اللغة باطمئنان " بائس "، وضمن فهم، ووعي " كسول " بعلاقاتها، ووظائفها، ومقولاتها. بل هي تنشئ " انتباه " عالي تجاه هذه اللغة، وتفتت المقولات المكررة والمباشرة للكلمات، لتعمل على إنشاء مقولتها الشخصية فيها، وتعيد توظيفها في سياقات، وتراكيب نصية مليئة بالذكاء الشعري واللغوي، الذي يعتمد أيضاً على إحساس عالي ويقظ، بالإمكانيات المهدرة لهذه الكلمات، والتي يُمكن إيجادها، وإعادة استثمارها، عبر " تفحص "، و" تفعيل " الكلمات ذاتها، و عبر إدخالها في وظائف جديدة، تنشط صور، وأفكار، وعلاقات مهملة، وبالتالي تعيد بناء تعريفات جديدة لها، مناهضة للاستخدام العام، وموصولة بالفرد الذي يستخدمها فقط، دون أن تجبره على أن يستعير صوت الجماعة، وتحيزاتها، التي كانت مُضمنه فيها، لكي يقول ما يريده هو، بشكل يُفصح عن الاستلاب الهائل لصوت الفرد، الذي توقعه به الكلمات، حين يستخدمها بكسل، وباطمئنان غبي يركن فيه لماهي عليه.
إذاً، لا تعمل إيمان مرسال في نصوص هذه المجموعة - والمجموعات السابقة أيضاً - على العمل اللغة باطمئنان " بائس "، وضمن فهم، ووعي " كسول " بعلاقاتها، ووظائفها، ومقولاتها. بل هي تنشئ " انتباه " عالي تجاه هذه اللغة، وتفتت المقولات المكررة والمباشرة للكلمات، لتعمل على إنشاء مقولتها الشخصية فيها، وتعيد توظيفها في سياقات، وتراكيب نصية مليئة بالذكاء الشعري واللغوي، الذي يعتمد أيضاً على إحساس عالي ويقظ، بالإمكانيات المهدرة لهذه الكلمات، والتي يُمكن إيجادها، وإعادة استثمارها، عبر " تفحص "، و" تفعيل " الكلمات ذاتها، و عبر إدخالها في وظائف جديدة، تنشط صور، وأفكار، وعلاقات مهملة، وبالتالي تعيد بناء تعريفات جديدة لها، مناهضة للاستخدام العام، وموصولة بالفرد الذي يستخدمها فقط، دون أن تجبره على أن يستعير صوت الجماعة، وتحيزاتها، التي كانت مُضمنه فيها، لكي يقول ما يريده هو، بشكل يُفصح عن الاستلاب الهائل لصوت الفرد، الذي توقعه به الكلمات، حين يستخدمها بكسل، وباطمئنان غبي يركن فيه لماهي عليه.
في مجموعة نصوص تم ضمها تحت عنوان رئيسي، بعنوان ( شبابيك المصحّة )، مع عنونة فرعية لكل موضوع مستقل ضمنها، تعمل إيمان على خلق تحيز لمجال أو مزاج لغوي حر، في إطار " شق " من المجموعة ذاتها، يميل في مجمله إلى العبث، و إلى تشتيت أي " فهوم " مباشرة وأولية - من تلك النوع الغبي والسطحي - يُمكن أن تُستخلص منها، مع ضخ كثيف لإحساس عالي بالتشوش والحزن في اغلبها، تأسيساً في كل ذلك على كونها نصوص " مصحة "، تنتمي إلى ذات الارتباك، وعدم الوضوح، والتطرف اللغوي، والنفسي، الذي يُميز نزلائها، والذي يبدوا كل نص فيها كأنه تسجيل لحلم أو " مشافهة " أحدهم. ذلك الـ " أحدهم " الذي قد يكون " هي " تماماً، بمشاعر وذكريات سرية مشوشة، في حالات لا واعية متعددة، تُجاهد لأن تدون نفسها على بياض أعمى، لا يُفترض به أن يستفسر عن ما تقوله، أو يُدينها لذلك!!. نص ( سُلّم إلى القمر )، يبدو أنموذجاً جيداً لهذا التشوش والحزن، بصوره " سريالية " مقتضبة، تم بنائها ضمن خلفية نفسية مُرتبكة، إن صح بالطبع استخدام كلمة مثل " سريالية "، كتوصيف ذو وظيفة إجرائية، في سياق التأويل الذي أمارسه على النص ( أفهمُ أن تبتلعَ الخلفيةُ الخضراءُ الأرضَ والجدرانَ أن يُثبَّت السلّم على فراغٍ أخضر حيث تبدو أيّة شجاعةٍ في الصعود قبولاً بأن لاشيء يحمي من التهشُّم لكن ماذا يعمل قمرُ " جورجيا أوكييف " في لوحتها؟ قمرٌ بلا معنى إنه حتى لا يصلُح نافذةً على حديقةِ المصحة. ).
أما نص ( أشباح )، فهو يُنصف الحزن السري، وقسوة الأشواق، والرغبات، والأحلام. يتلصص على امرأة تملك ما يكفي من التحريض لان تجابه المعايير العامة، في السلوك والتصرف، وتعيش ارتباكها وحزنها بعبث وحرية كاملين، ضمن تدوين نصي يبدو كمقطع سينمائي، مشغول بنفس المزاج الذي تُصنع به أفلام تنحاز بقوة نحو " تصوير "، و" التقاط " أحلام ورغبات الأفراد، وهي مُعرضة بقسوة للهواء، والرغبة بالاكتمال. إنه نص عاري وجارح، يتضمن تهكماً شديداً على الضعف، ذلك الذي ينتابنا أمام أي مشهد عام، ومفتوح أمام الأخريين ( حيث لا يَجْرؤ على الغناءِ في القاهرة إلا المجانين )، وإنصاتاً شديداً للغرائز، والرغبات المفاجئة، وحزناً نبيلاً منها، يأكلنا حين لا ندرك ماذا كنا نشتهي منها في تلك اللحظة، و في ذلك الاندفاع ( نزلتُ في محطةٍ لا أعرفُها واشتريتُ فستاناً مكشوفَ الظهر، وكتبتُ في بارٍ سبع رسائلَ غراميةٍ لشخصٍ أكرهه، ثم خلعتُ حذائي مقلّدةً بطلات أفلام الأبيض والأسود الهاربات من الماضي، وأتذكرني الآن بكارتٍ للتليفون الدوليّ بين أسناني؛ أطلبُ الرقم الخطأ بآخر قروشٍ معي وأبكي، ولكني لا أذكرُ من هو الآخر الذي أطلب رقمه صحيحاً وهذا ما يُحزنني بعد كل هذه السنوات. ).
إن إيمان مرسال، في هذه النصوص المنضوية تحت هذا العنوان الفرعي ( شبابيك المصحة )، تحاول أن تفلت من سيطرة ( الاغتراب )، و( الذاكرة ) وتداعياتهما، على فضاء المجموعة، وبالتالي هي تُفصح كما اعتقد، عن نفورها من إنتاج فرز غبي يكتفي بتصنيف تعبيرها الشعري في هذه المجموعة، في خانة " حنين المغترب " الساذجة، وهي الخانة التي تُعاديها ضمناً في بعض النصوص كما أسلفت سابقاً. ولذلك تحاول الإفلات من هذه السيطرة الضمنية، أو التصنيف، لتشكل هذا الانطباع الأولي لدى المتلقي، وسيطرته عليه، ضمن ذات الفكرة، وبالتالي سيتم حرف انتباهه أثناء عملية قراءة المجموعة، نحو التفتيش عن " براهين "، تتحقق عبرها " صدقيه " كاملة لهذا الانطباع، والذي يتكون ضمنياً لدية، من تلقيه العياني المباشر، للدلالة الأولية التي تنتجها العتبة الأولى في المجموعة، أي عنوانها ( جغرافيا بديلة )، وهو التلقي الذي يتعزز بنفس الانطباع، حين يتم تلمس مزاج النصوص الأولى أيضاً ( لماذا جاءتْ )، و ( يهدمون بيت أهلي ) و ( قراءة الماضي ). هذا السعي للتفلت من هذا الاحتكار، أو التصنيف، الذي يعتمد على السطوة الدلالية لعنوان المجموعة، ولمزاج النصوص الأولى، يتضح أيضاً - بالإضافة إلى ما سبق ذكره - في نصوص أخرى، مثل ( الغرام )، و ( دكَّانُ خرائط )، و( الحرب )، و
( الدولة ) وغيرها من النصوص، التي تشتبك معها بذكاء وخفة ممتعة، عبر تأملات عميقة ونابهة، بـ تفاصيل، وأمكنة، وبشر، وأفكار، وأمزجة من خارج موقع " المهاجرة "، أو " الغريبة " بالطبع، متجهة هنا نحو موقع جديد، تتحول فيه إلى عين متكئة على رصيف مقابل للحدث، أو الفكرة، التي تستبطنها في النص، مُفككه هذه " الأحداث "، أو " الأفكار "، قيد النظر، إلى عناصرها الأولية، وعبر سردية شعرية، تُعري مقولتها السرية، وتكشف عن انطوائها على رمزيات ثقافية، ونفسية، شديدة الدلالة..
http://magedpress.blogspot.com/2008/01/blog-post_21.html